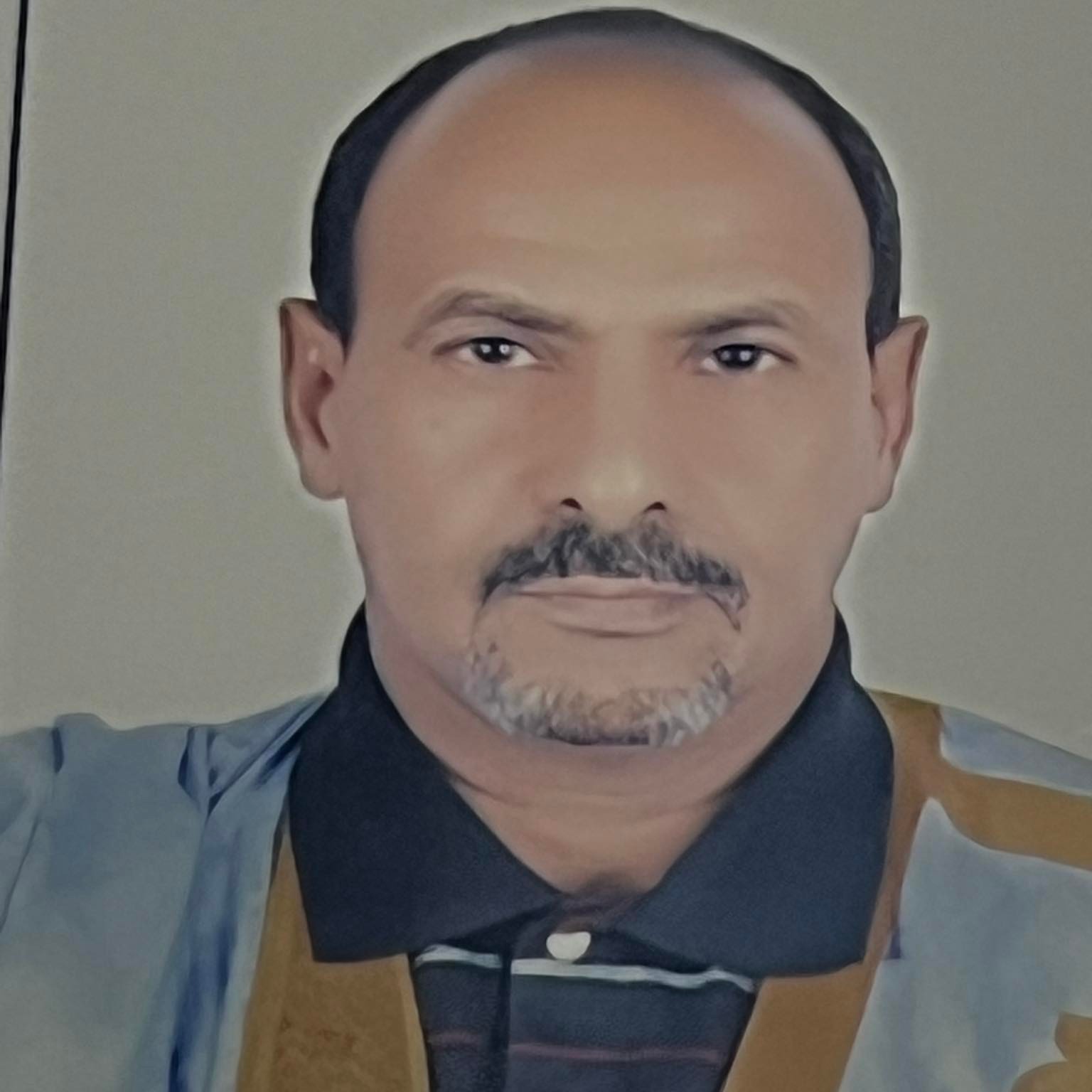
عندنا ، أصبح لفظ الحوار متداولًا إلى حدّ الابتذال، بل أقرب إلى التعويذة السياسية. فمع كل أزمة سياسية، ومع كل انسداد أو احتجاج، يُستدعى الحوار بوصفه الحلّ النهائي، والعلاج التوافقي لجراحٍ عميقة تضرب كيان الدولة والمجتمع. غير أنّ تكرار هذا النداء دون نتائج ملموسة جعل الحوار يثير الشكّ أكثر مما يبعث على الأمل. ومن هنا يظلّ السؤال الجوهري مطروحًا بإلحاح: إلى أين يمكن أن يقودنا الحوار فعليًا؟
من حيث المبدأ، يُعدّ الحوار السياسي أداة نبيلة. فهو يفترض الاعتراف المتبادل بين الفاعلين، وقبول التعدّد في الرؤى، والاستعداد الصادق للبحث عن تسوية تسمو فوق المصالح الضيقة. وفي بلد مثل موريتانيا، عرف تاريخًا مؤسسيًا مضطربًا، وانقطاعات دستورية متكرّرة، وحالة مستمرة من انعدام الثقة بين السلطة والقوى السياسية والشعب، كان من الممكن للحوار أن يشكّل فرصة تاريخية. فرصة تفتح الباب أمام إعادة تأسيس الدولة على قواعد قانونية صلبة، تضمن تكافؤ الفرص، والمواطنة الكاملة، والفصل الحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
غير أنّ هذه الإمكانية الإيجابية تصطدم بواقع ثقيل: تجربة الحوارات السابقة. فقد نُظّمت هذه الحوارات في الغالب من قبل السلطات القائمة، وأُحيطت بإطار مُتحكَّم فيه من حيث جدول الأعمال وحدود النقاش، وأحيانًا حتى في خلاصاتها. ونادرًا ما أفضت إلى تحوّلات بنيوية عميقة. بل كثيرًا ما استُخدم الحوار وسيلةً لكسب الوقت، أو لتحييد المعارضة، أو لتفكيك القوى السياسية، أو لإضفاء طابع توافقي شكلي على قرارات محسومة سلفًا. وهذه التجربة المتراكمة تطرح سؤالًا مشروعًا: هل تتحلّى السلطات فعلًا بالصدق حين تدعو إلى الحوار؟
إن صدقية الحوار لا تُقاس بالإعلان عنه، بل بشروطه. فالحوار الجاد يقتضي أولًا إطارًا جامعًا، تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية ذات الوزن الحقيقي دون إقصاء تعسفي. كما يتطلّب حرية فعلية للنقاش، بلا خطوط حمراء مُسبقة، ولا سيما في القضايا الجوهرية: طبيعة النظام السياسي، توازن السلطات، استقلال القضاء، دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، والضمانات الدستورية للحقوق والحريات. وفوق ذلك، لا يكون الحوار صادقًا إلا إذا اقترن بالتزام واضح بتحويل مخرجاته إلى إصلاحات ملزِمة، لا إلى توصيات شكلية تُركَن في الأدراج.
وفي غياب هذه الشروط، قد يُفضي الحوار إلى عكس غايته. فبدل أن يقرّب السلطة من الشعب، قد يوسّع الهوّة بينهما، ويُعمّق منسوب الشكّ، ويعزّز شعور الإقصاء السياسي. وحين يُفرَّغ الحوار من مضمونه، يتحوّل إلى عامل إضافي من عوامل الإحباط، وربما إلى بذرة لاضطرابات مستقبلية. إذ إن شعبًا يفقد الثقة في آليات التغيير السلمي، قد يلجأ في نهاية المطاف إلى مسارات أخرى، غالبًا ما تكون أكثر كلفة على الوطن واستقراره.
وعلى النقيض من ذلك، إذا أُدير الحوار بشجاعة سياسية وباستحضار صادق للمصلحة العامة، فإنه قد يفتح آفاقًا مقبولة، بل واعدة. إذ يمكن أن يشكّل منطلقًا لـ إعادة تأسيس جمهورية حقيقية، قائمة على دولة قانون فعلية، لا تختلط فيها المؤسسات بالأشخاص، ويُخضع فيها الجهاز التنفيذي لرقابة حقيقية، ويضطلع فيها البرلمان بدوره الكامل، ويكون فيها القضاء مستقلًا، حاميًا لحقوق المواطنين، لا أداة في يد السلطة. ولن تكون هذه الإعادة للتأسيس مؤسسية فحسب، بل أخلاقية وسياسية أيضًا، تعيد المصالحة بين الدولة والمجتمع.
وخلاصة القول، إن الحوار ليس غاية في حدّ ذاته، ولا ضمانة آلية للتقدّم. إنه أداة، تتحدّد قيمتها بنوايا من يديرها، وبعمق التحوّلات التي تُفضي إليها. موريتانيا لا تحتاج إلى حوارٍ إضافي، بل إلى حوارٍ للحقيقة، حوار يقطع مع ممارسات الماضي، ويفتح دورة سياسية جديدة. وحده هذا النوع من الحوار كفيل بأن يجعل منه أساسًا لإعادة تأسيس مستدامة، ولمستقبل مشترك يقوم على العدالة، والمساواة، والفصل الحقيقي بين السلطات.


.gif)
.jpg)


.jpg)
.jpeg)